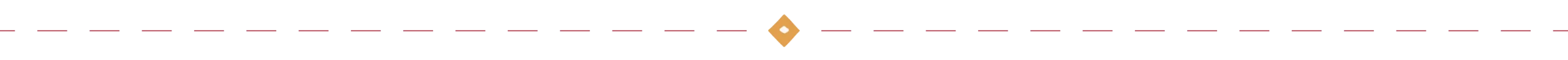يجابه مصرف ليبيا المركزي كورنيش طرابلس. خلف المصرف، وبمنأى عن أنظار الكورنيش وناسه، تتناثر في ميدان “الساعة” الضيّق دوائر صغيرة لتجّار العملة، وتتزعم دوائرنا هذه دائرتان أو ثلاث، تنصهر في اقتران السوق السوداء بأكبر مؤسسة مالية. يعمل أغلب مدراء بورصة الهواء الطلق هذه كوسطاء لكبار التجّار، ولكلٍّ نسبته من الربح.

بوابة الدخول
عقب انتفاضة 17 فبراير، 2011، عرضت أغلب المصارف الكبرى خدمة بطاقات “الأغراض الشخصية”، وكان جلها بطاقات Visa توفر للزبون 5000 دولار (آنذاك تُصدَر ب 7500 دينار). وحسب الحاج عبد المنعم، أحد التجّار في مدينة البيضاء، شرقي البلاد، لم تلقَ هذه الخدمة رواجًا، فالعملة الصعبة متوفرة، فتوفرت السيولة.
ستخلق أزمة حرب 2014 – المستمرة بشكل أو بآخر إلى يومنا هذا – انقسامًا في أغلب قطاعات الدولة، لا سيما المصرفية. ذاك أن ثقة المواطن لا تتأتّى من حكومتيْن ومصرفيْن وجيشيْن.
سارعت الحكومات، المتمتعة باعتراف دولي، إلى رأب الصدع واجتراح الحلول، كما تحب التقارير أن تسرد. فبعد سنتيْن أو ثلاث، تحولت بطاقة 5000 دولار إلى بطاقة 10000 دولار، في برنامج حكومي يحاول أن ينقذ الدينار من الانهيار (4000 دولار هذه الأيام). بيعت هذه البطاقات في السوق السوداء ب 53000/52000 دينار، وهي الصادرة بحوالي 45000 دينار من الزبون/المواطن.

أرباب الأُسَر في أسْر الحاجة
وما إن تعرّف المواطن على آلية الاشتغال ببطاقته – أي بيعها “فارغة” لتاجر العملة – “دُشِّن” حينها برنامج بطاقات أرباب الأسر، حيث خُصِّصَ لكل فرد عائلة 500 دولار، يُدفَع لإصدارها 750 دينار. إذًا، لا يزال الدينار “مدعومًا” بسعر الصرف. هنا يبيع رب الأسرة بطاقته للتاجر كما أسلفنا.
في 2017، بلغت قيمة الدولار ذروتها في السوق السوداء، فقارب 10 دينار. على أن الفترة قصيرة نسبيًا، وخليقٌ بعالمِ اقتصاد تفكيك مآربها وأسبابها. أما أنا القاصر على تعقيدات المال والتجارة، أنقل ما يسرده عبد المنعم من إيجابيّات وسلبيّات.
في أيامنا هذه لم يعد سعر الصرف على حاله في المصرف المركزي، فقد انخفضت القيمة إلى ما ينيف على 5 دينار مقابل الدولار في السنتيْن السابقتيْن. فيما يخص هذا التداول، نرى علاقة الدولة/ رجال الأعمال/ المواطن تكافلية (التفرقة بين المواطن والتاجر ليست طبقية، بل بحسب عدد البطاقات المشحونة). فما دام ثمة هامش ربح ضئيل في السوق السوداء، الكل رابح. ولعل هذه المعادلة ناجعة في دول الأزمات كافةً.

هنا نجحت الدولة، من طريق الحكومات العرجاء، في السيطرة على العملة الصعبة، كما يرى عبد المنعم. بيدَ أن كل انفتاح، تقريبًا، يلازمه الفساد.
في المنطقة الشرقية، حُدٍّدَت مدة شحن البطاقات، بعكس العاصمة. تشكّلت هنا عناصر الفساد في الرشاوي المدفوعة إلى موظف شحن البطاقات في المصارف، والرشاوي مجبولة على وفرة المال، ووفرة المال تأتي بوفرة البطاقات. فلكل مجموعة بطاقات عمولة لموظف الشحن، وهي مجموعة تخص فردًا/تاجرًا. هنا تتعطل خدمة المواطن ذو البطاقة الواحدة (أو قل 5 بطاقات، إذا مُنِيَ – أو أبتُليَ – بخمسة أبناء وبنات). ثمة من فهم اللعبة، فلجأ مباشرةً إلى شحن بطاقات عرمرم في المنطقة الغربية، غالبًا في طرابلس.

وعن التمييز، نراه ماثلًا أولًا ضد الزوجة، فهي خارج المعادلة تمامًا. على أن الاستقلال الاقتصادي للزوجة لا يتأتّى أصلًا من برامج حكومية، فيظل هذا التمييز شكلًا قديمًا من أشكال توزيع الثروة. على الضفة الأخرى، يطال التمييز درجات الثروة، فتسهيل معاملات أصحاب البطاقات الذهبية وأخواتها، تتمايز بحدة مع خدمات العميل العادي، صاحب المئة أو مائتيْ دولار.

أحتفظُ في درج “أغراضي الشخصية” بديناريْن صُدِرا عن حكومة طرابلس، لا يصلح تداولهما في مدينتي البيضاء، حاله حال الدينار “الشرقاوي” في الغرب. فكما انفصمت المؤسسات، انفصم الدينار، فصار الوحدة النقدية الوحيدة المنقسمة بين شرق وغرب؛ تراه في الأولى عملة معدنية، وفي الأخيرة ورقية (بلاستيكية). هذا الاحتفاظ – أو قل الاكتناز – تجسيدٌ لعبثٍ مجتمعي سينجلي يقينًا، فيُستبدَل بآلية عبث أخرى.
إلى ذاك الحين، قد يشتري هذان الديناران ما يُشترَى في البيضاء بعد الاعتراف بهما. السؤال يبقى: أين يقبع آخر موقع تجاري، بالتحديد، يعترف بالدينار الشرقاوي، وأين يقبع نظيره الغرباوي؟ طرافة البحث تمضي صوب الجنوب، حيث تتعقد هوية الدينار في خضم تعقيدات إقليم منسي.